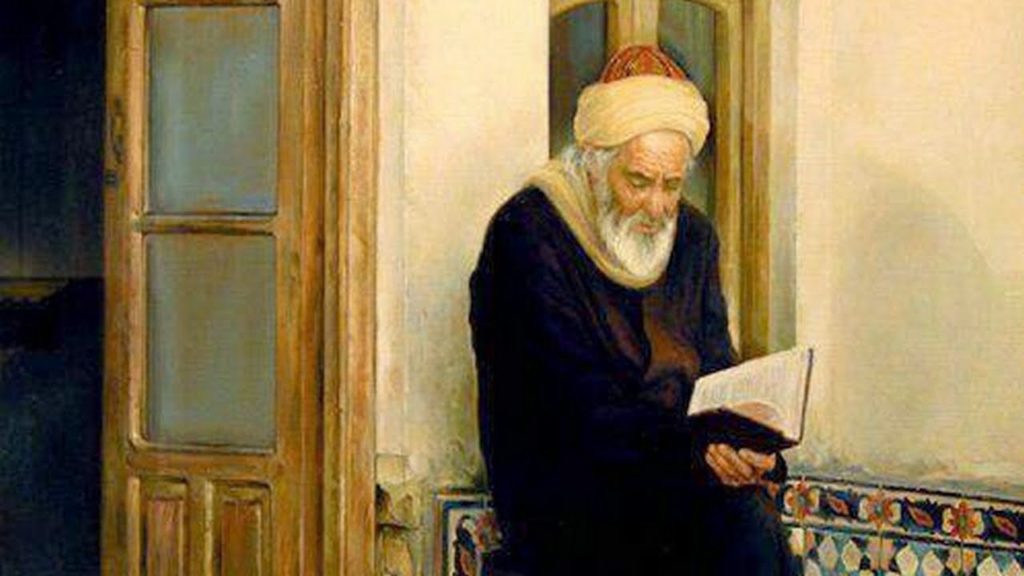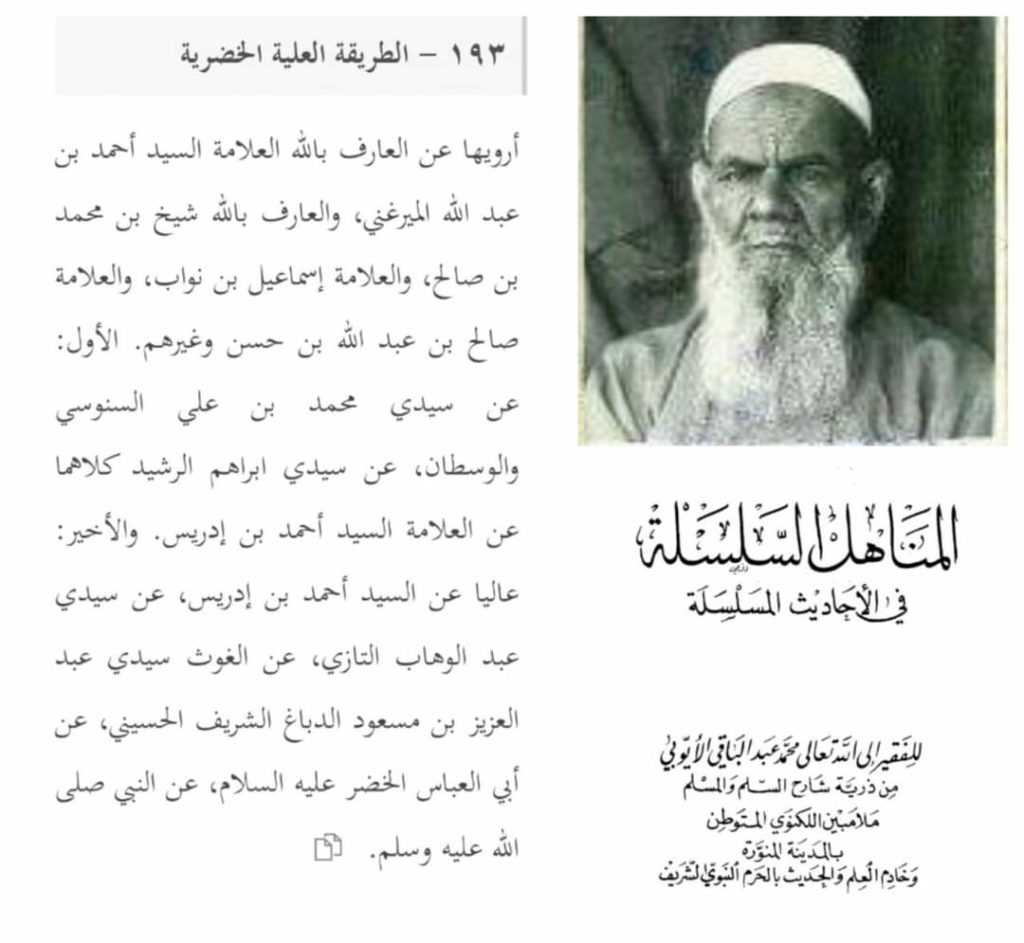التصوف الفلسفي للإمام الغزالي من خلال كتاب مشكاة الأنوار ج 2
5 دقائق للقراءة
ب: معنى التصوف الفلسفي:
التصوف الفسلفي تيار من تيارات التصوف، يتعلق بالجانب التأملي، ورؤية الصوفيين للوجود، ولعوالم الغيب والشهادة، والميتافيزيقيا، ومعاني الفناء وأحوال أهل المواجد، فيكون اشتغالهم بتفسير تلك الأحوال وما يعتري أهل الجذب في سكرهم، والوجد في عشقهم. كما أنه تفكر فلسفي في الأحوال الروحية والمقامات العرفانية وحقيقة المعرفة وفي الإلهيات وعلوم الباطن، وكذلك في ماهية الإنسان وفي التفكر الوجودي وغير ذلك، ضمن تفاعل مع الفلسفة المشائية الأفلاطونية والأرسطية ومنهج سقراط الفلسفي، وكذلك مع فلسفات أخرى كالفارسية والهندية وغيرها، ضمن ما كان من تلاقح حضاري وثقافي في العالم الإسلامي في القرنين الثاني والثالث وما بعدهما.
ومن مدارس التصوف الفلسفي نجد مدرسة الإشراق للسهروردي المقتول في قلعة حلب سنة 586 للهجرة. وتعني الفلسفة الإشراقية الصوقية «ظهور الأنوار الإلهية في قلب الإنسان الصوفي (العارف)» وكذلك تم تعريفها على أنها «معرفة الله من طريق الكشف أو نتيجة لانبعاث نور من العالم غير المحسوس”. وتقوم على المعرفة عند السهروردي على الحدس والكشف وعلى الجواهر النوارنية في اتصالها بالذات العارفة، وفي ذلك يقول: “من يبحث عن الحقيقة من خلال البرهان كمن يبحث عن الشمس بواسطة المصباح”.
وكذلك كان للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي (ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان عام 558 هـ / 1164م ، وتوفي في دمشق عام 638هـ / 1240م.) إبحار عميق في الفلسفة الصوفية والذي سمي ببحر الحقائق ورئيس المكاشفين، وكان من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين بل وفي الفكر الإنساني كله. ويعتبر كتابه “الفتوحات المكية” من أعاجيب ما أنتج الفكر الصوفي الفسلفي، وما حواه من مكاشفات وأحوال وأسرار. وقد دوّن الإمام الرواس أيضا مكاشفاته وأحواله في كتبه وقصائده، ولكنها لم تكن فلسفة بقدر ما كانت أحوالا وفيوضات.
وفي هذه الأطر الصوفية الفلسفية والمعاني الذوقية الإشراقية، وفي اتصال بجواهر النور ومعانيه ولطائفه، وبالذات الإنسانية وبواطنها الروحانية، كان كتاب “مشكاة الأنوار” للإمام الغزالي الذي يعد أيضا من كبار أهل التصوف والفلسفة، وسوف نمضي إلى تعريف موجز به وبكتابه، ثم نغوص قليلا في بعض معانيه، لنفوز بدرر عرفانية بديعة، ولنتذوق معاني راقية، ولنشهد مشكاة النور ونرى كيف فسر الإمام الغزالي آية النور وإلى أين حملته أمواج العرفان والكشف وأشرعة الذوق والمعرفة.
2/ التعريف بأبي حامد الغزالي.
جاء في موقع ويكيبيديا ضمن التعريف بالإمام الغزالي: “أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، (450 هـ – 505 هـ / 1058م – 1111م). كان فقيهاً وأصولياً وفيلسوفاً، وكان صوفيّ الطريقةِ، شافعيّ الفقهِ إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثلَه، وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة، وقد عُرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام، وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعري، (وكانوا الباقلاني والجويني والغزّالي). لُقّب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته، أشهرها لقب “حجّة الإسلام”، وله أيضاً ألقاب مثل: زين الدين، ومحجّة الدين، والعالم الأوحد، ومفتي الأمّة، وبركة الأنام، وإمام أئمة الدين، وشرف الأئمة.
كان له أثرٌ كبيرٌ وبصمةٌ واضحةٌ في عدّة علوم مثل الفلسفة، والفقه الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، وترك عدداَ من الكتب في تلك المجالات. ولد وعاش في طوس، ثم انتقل إلى نيسابور ليلازم أبا المعالي الجويني (الملقّب بإمام الحرمين)، فأخذ عنه معظم العلوم، ولمّا بلغ عمره 34 سنة، رحل إلى بغداد مدرّساً في المدرسة النظامية في عهد الدولة العباسية بطلب من الوزير السلجوقي نظام الملك. في تلك الفترة اشتُهر شهرةً واسعةً، وصار مقصداً لطلاب العلم الشرعي من جميع البلدان، حتى بلغ أنه كان يجلس في مجلسه أكثر من 400 من أفاضل الناس وعلمائهم يستمعون له ويكتبون عنه العلم. وبعد 4 سنوات من التدريس قرر اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربية نفسه، متأثراً بذلك بالصّوفية وكتبهم، فخرج من بغداد خفيةً في رحلة طويلة بلغت 11 سنة، تنقل خلالها بين دمشق والقدس والخليل ومكة والمدينة المنورة، كتب خلالها كتابه المشهور إحياء علوم الدين كخلاصة لتجربته الروحية، عاد بعدها إلى بلده طوس متخذاً بجوار بيته مدرسةً للفقهاء، وخانقاه (مكان للتعبّد والعزلة) للصوفية”.
وبعد تبحره في الفلسفة ثم نقده لها، وتبحره في علم الكلام، وفي الفقه قبل ذلك، وفي عدد كبير من المعارف، وبلوغهم صيتا عاليا ومجدا كبيرا ورفاه، كان للغزالي موعد مع التصوف “بعد خوض الغزالي في علوم الفلسفة والباطنية، عَكَف على قراءة ودراسة علوم الصوفية، وصحب الشيخ الفضل بن محمد الفارمذي (الذي كان مقصداً للصوفية في عصره في نيسابور، وهو تلميذ أبو القاسم القشيري).[ فتأثر الغزالي بذلك، ولاحظ على نفسه بعده عن حقيقة الإخلاص لله وعن العلوم الحقيقية النافعة في طريق الآخرة، وشعر أن تدريسه في النظامية مليء بحب الشهرة والعُجُب والمفاسد، عند ذلك عقد العزم على الخروج من بغداد”.
فقد تاقت روحه إلى كسر قيود ما حوله من نمط التدريس وما في عالم المرفهين وأهل الجاه من مفاسد، وفي ذلك يقول: “ثم لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي – وأحسنها التدريس والتعليم – فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة، ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشفيت على النار، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال.. فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا، ودواعي الآخرة، قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة 488 ه. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة. ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب”.
وتعتبر هذه المرحلة مفصلية في حياة الإمام الغزالي الذي قال: طلبنا العلم لغير الله فما أراده الله إلا له”، وعبّر عن حاله ذاك بقوله: “نور قذفه الله في صدري”.
وقد كانت للإمام الغزالي مكانة علمية كبيرة وعبقرية فريدة، حتى قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج9 ص 323 : ” الغزالي الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط تَفَقَّه ببلده أولاً ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين..”
وقد كان تصوف الإمام الغزالي تصوف العالم الذي أتقن الفلسفة والعلم الكلام، وكان من الفقهاء الكبار ومن العلماء بالقرآن والحديث، وبالعقيدة والشريعة بل يعد من أركان المعتقد الأشعري، ولكنه آثر التصوف وغاص فيه وقرأ لأقطابه ودرس كتبا كثيرة ” مثل: قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد وأبي بكر الشبلي وأبي يزيد البسطامي. كما أنه كان يحضر مجالس الشيخ الفضل بن محمد الفارمذي الصوفي، والذي أخذ عنه الطريقة، فتأثر بهم تأثراً كبيراً، حتى أدّى به الأمر لتركه للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد، واعتزاله الناس وسفره لمدة 11 سنة، تنقل خلالها بين دمشق والقدس والخليل ومكة والمدينة المنورة، كتب خلالها كتابه المشهور في التصوف إحياء علوم الدين، وكانت نتيجة رحلته الطويلة تلك”
وقد جرّب الخلوة مرارا، وغاص في عوالم الكشف حتى قال: “وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمتُ يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق”.
وكتابه “إحياء علوم الدين” من أهم وأثرى كتب التصوف، فهو من مراجعه الكبرى كالرسالة القشيرية، وكما أن له كتبا كثيرة في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق، وفي الفقه وأصوله وعلم الجدل، وفي التصوف، وفي فنون أخرى، ولكننا سنبحث في كتاب من كتبه لعله لم يحظ بالعناية والشهرة التي حظي بها كتاب إحياء علوم الدين، ألا وهو كتابه “مشكاة الأنوار”.
# الإمام الغزالي، التصوف، التصوف الفلسفي، الدكتور مازن الشريف، الطرق الصوفية