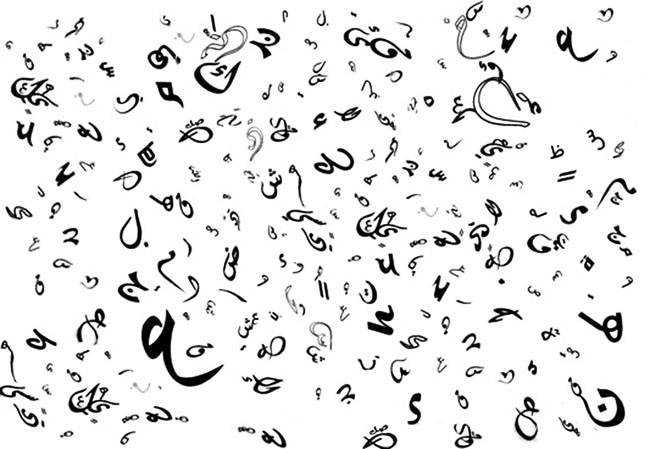كتاب تأملات فلسفية:اللوح الرابع: في المفهوم والمصطلح
4 دقائق للقراءة
عندما نتأمّل المصطلحات، ونتأمل في المصطلحات، أي المبنى والمعنى، والشكل والمحتوى، فإن كل تأملاتنا على عمقها وجهدها ومحاولاتها الصادقة للفهم والتطوير، تجد أمامها جدرانا ترتفع كل مرة أكثر، وأسوارا تحاول باستماتة أن تجعل العبور مستحيلا، لأن بين دقة المصطلح وقوة مبناه وجمال معناه، وبين تطبيقه وتحققه الواقعي، مسافات ومساحات من القصور والعجز والمرض التطبيقي يجعل ذلك المصطلح تهويما معجميا وترفا اصطلاحيا لا أكثر.
لعل لهفة السؤال تكون خير مدخل لولوج كون المصطلح ضمن التحديد المفهومي، ثم يكون التزاوج الاصطلاحي بين المفاهيم المولّد للقضايا، فالمفهوم بوتقة اصطلاحية بمعنى صارم، أما القضية فنتاج لقاح ولقاء بين مفهومين، فإن صحت العلاقة صحت القضية، وإن ثبت بطلانها، فهي زائفة.
ومما صنع الإنسان حرب على المصطلح والمفهوم وتزييف للقضايا ضمن محاولات باهتة لـمَنطقة ذلك الزيف مستخدما كل فنون التمييع والتلميع والخداع المثقف والإفك المتفنن والبث الممنهج والتخطيط المجرثم لتفعيل زمني تصاعدي وشمول مكاني مخترق لصنوف المسخ القيمي والسلخ المفهومي والتزييف الخطير لجوهر القضايا الإنسانية.
“الوطن” مثلا مفهوم، حاو للكثير من المعاني المنضوية ضمن مبناه، فهو الأرض وهو الهوية وهو التاريخ والمستقبل وعلاقات الإنسان الأجمل والأعمق بالمكان. أما “الأنا” فمفهوم للذاتية والخصوصية الفردية، وكل من “الوطن” و”الأنا” مصطلحان لغويان اصطلح الإنسان عليهما مع تغيير لفظي حسب اللغة، لكن المفهوم الإنساني هو ذاته على تغير اللغات وتبدل الألسنة.
حين يقع اللقاح بين المفهومين، تكون القضية الجامعة المنتجة لمصطلح جديد: “وطني”، إنه انصهار بين مفهوم الوطن بكل ما يحمله ويحويه، مع الذات بكل خصوصياتها وخصائصها، فيكون مصطلح “وطني” لقاء بين مفهومين ويشكل قضية جوهرية من قضايا الإنسان، فوطني هويتي، وهو ذاتي وروح إنسانيتي، إنه أرضي وعرضي وماضي وحلمي…وعلى شاعرية هذه الكلمات فإنها لصيقة بالحقيقة المجردة، ولكن حين ننظر في مدى التحقق بين الوطن والأنا، مستعينين بعلوم التاريخ وحقائقه وبفنون الجغرافيا ودقائقها، وبالراهن المعاش أو القديم الموثق، نجد أن قضية الوطن والأنا قضية لم تسلم من يد التزييف والحرب المفهومية، والتي ساندتها كل صنوف الحروب الأخرى، فحين يقول صاحب وطن ما: “هذا وطني”، ويثبت التاريخ وتشهد الجغرافيا أن العلاقة بين ذلك الوطن وتلك الأنا علاقة حقيقية مثبتة، فإن القضية صحيحة وإن كل ما يفعل صاحبها من أجل الدفاع عن تلك القضية مشروع وواجب.
أما حين يأتي منبتّ عن المكان ظرفي في الزمان ضمن تلاحقات حدثية وتدافعات نوعية أوصلته بقوة ما أو طريقة ما إلى التملك بوطن ينتمي لذوات أخرى ثم يكون البيان المفضي لقضية “وطني” بيانا مشبعا بكل قدرات البطش والتزييف فيقول من اغتصب أرضا وافتك وطنا: “هذا وطني”، فحينها تكون القضية باطلة بالكلية، ولكن لذلك الباطل غالبا من القوة ما يجعله يفرض تلك لقضية المزيفة على القضية الحقيقية، ولابد لصاحب القضية الحقيقية من قوة أكبر كي يعيد الأحقية الفعلية للقضية.
ذات الأمر في مفاهيم كثيرة مثل الحرية، فحين أقول هذه حرية، أي ربطت بين جهة أو تصرف أو فعل أو شيء وبين الحرية، وخلقت قضية توجيهية أحصر فيها وأبرهن بها عن فهم ما للحرية، أو حين أقول “حريتي” رابطا بيني وبين الحرية، أو “هذه حريتي” رابطا بين وبين الحرية وبين تصرف لي أو فعل أو رغبة، فإن التحقق الفعلي للقضية ضمن ضوابطها المنطقية لا يتم إلا بتوفر شروط المفهوم نفسه ومعان المصطلح ذاته، فالحرية التزام، ومجال، إرادة وطاقة، أم تصرفي وذاتي فعليها أن تلتزم صدقية الالتزام وعدم تداخل مجال حريتي مع مجال حرية من يشاركني حق الحرية وحق المجال، وأن لا تخل إرادتي للحرية وطاقتي في استثمارها مع الحد أو الإضرار مع حرية السوى، أو مع استحقاقات الواجب، مع عدم ملامسة الانعدام القيمي وعدم الغرق في اللاجدوى وفي الإسفاف والانفلات الكلي.
لكل المصطلحات والمفاهيم والقضايا قواسم مشتركة، وتخضع كلها لقوانين ثلاثة: قانون المعنى الفعلي، قانون المعني التطبيقي، وقانون المعنى بالقوة.
فالمعنى الفعلي هو الحقيقة النظرية المجردة لمصطلح أو مفهوم أو قضية.
والمعنى التطبيقي هو مدى تحقق النظري على الصعيد الملموس الفعلي الواقعي. أما المعنى بالقوة فهو معنى يفرض فرضا على المستوى التنظيري والواقعي بالقوة والإجبار ليلائم غاية ويكون وسيلة دون أي رابط فعلي وحقيقي مع المعنى النظري وتحققاته.
حين يغلب المعنى بالقوة تزيف المفاهيم وتبدل القضايا أو تفرّغ، ويمكن القياس على جميع المستويات الخاصة بالإنسان ذاتا وحضارة، فكرا أو واقعا، مجتمعا أو سياسة….
لابد إذا من مراجعات عميقة وعمل دءوب لإنقاذ المفاهيم والقضايا من حرب عنيفة متجذرة، ما هي باختصار إلا حرب ظلمة بعض بني الإنسان على بوارق الضوء فيه.
حين تكلم سقراط وأفلاطون أرسطو وأفلوطين ومن كان في مدرستهم عن القيمة وحددوا لها المعنى والمفهوم وربطوها بالمصطلح الفعلي والقضية الحقيقية ملامسين قضايا الأخلاق والجمال والمعرفة والإنسان فكانت فلسفات العلم والإنسان والأخلاق والجمال وعلومها، فإن الصرامة المفهومية والالتزام المبدئي بصدقية القضايا كانت ميزة للتوجه الفلسلفي الذي ما كان ضمن مصطلحه ومفهومه وقضيته إلا حب للحكمة، والحب مصطلحا ومفهوما، بتزاوجه مع الحكمة مصطلحا ومفهوما، شكلا جسد الفلسفة (فيلوس صوفيا) كقضية ومصطلح جديد، لأن من بين خصائص القضايا أنها تتولد من المفاهيم وتولّد المصطلحات.
لكن الفلسفة العندية شكلت انقلابا فارقا على المفاهيم والقضايا إذ أن القيمة مرتبطة بالعند فأخلاق العفة مثلا إن قلت إنها قيمة كبرى يقال لك هي قيمة عندك ولكن ليس عندي، وذاك الأمر سيء يقال سيء عندك وجيد عندي، فتصبح القيمة مجردة من حقيقتها متبدلة حسب النوازع والرغبات، وتصبح كل الأحكام والنظم والقضايا زئبقية الشكل والمحتوى، وليس لهذا علاقة بالنسبية كما يفهم اليوم في ربط نمطي غير صحيح بين السفسطائية والنسبية، ولكنه في الحقيقة خروج قصدي عن صدقية وصرامة المنهج الأفلاطوني الأرسطي وما كان من وصايا سقراط وتأملات أفلوطين ومن اندرج في نهجهم الفلسفي.
كما أن الفلسفة الكلبية رفضت العرف وقيمه، ورامت التحرر من كل قيمة إجرائية ولئن ادعت الفضيلة، ورفضت الدين والأخلاق وكل مقومات الحياة الاجتماعية، متأثرة ضمن فلسفاتها كلها بفكر وحياة أنتيسيتنيس (القرن الرابع قبل الميلاد) مؤسس الكلبية، والذي تقمص ذاتية الكلب في الحياة وفي الخمول والإهمال وتميز بالإحباط الكلي من كل شيء وإهمال العائلة والمال وكل فعل إيجابي، وبقيت تأثيرات هذا الفكر وما شاكله مستمرة بأشكال مختلفة تنتقل من حضارة إلى أخرى تشوه المفاهيم وتموّه القضايا.
حتى المنطق على صرامته وقوته لم يسلم، فإن مصطلح منطق ومفهوم المنطق وقضية “هذا منطقيّ” خضعت لفعل الإنسان الذي تناول الأمر من زوايا تناقضية فهذا الفعل يبدو منطقيا لدى تلك الذات وغير منطقي لدى الأخرى، منطقيا لدى حضارة وغير منطقي لدى سواها، ولكن كيف للإنسان أن يتبين ما المنطقي حقيقة وما المنطقي مقاربة، وكيف يستبين المنطقي بالفعل والمنطقي بالقوة، إنها دعوة ملحة لرحلة في المنطق.