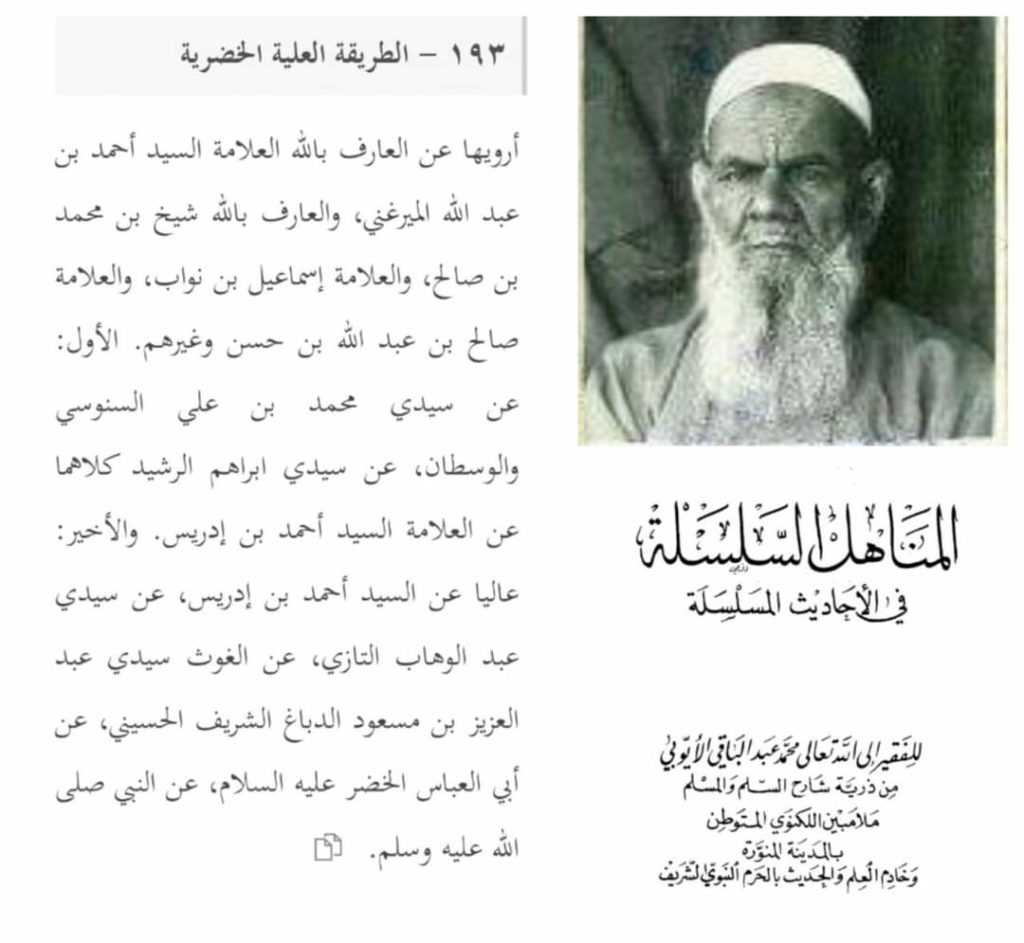موسوعة البرهان، الجزء الأول (15): العلم بالله (5): رحلة الإيمان (2)
2 دقائق للقراءة
وقمة هذه المرتبة من الإيمان بالله ما أسميته التسليم للموجد، فيكون إسلام الوجه لله وتسليم لحكمه وحكمته وهو باب الإيمان المحض، أن يسلم المؤمن وجهه لله، يسلم كل حياته ومصيره، وأن يكون محسنا، فاعلا للخير، فذلك من شروط صدق التسليم ومصداقية المسلِم المسلّم لله، فتلك حنيفية السلام، وذلك “أحسن الدين”، فتأمل قوله سبحانه: ” وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)” ..
والحنيف في لسان العرب هو: “الـمُسْلِمُ الذي يَتَحَنَّفُ عن الأَدْيانِ أَي يَمِيلُ إلى الحقّ، وقيل: هو الذي يَسْتَقْبِلُ قِبْلةَ البيتِ الحرام على مِلَّةِ إبراهيمَ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقيل: هو الـمُخْلِصُ، وقيل: هو من أَسلم في أَمر اللّه فلم يَلْتَوِ في شيء، وقيل: كلُّ من أَسلم لأَمر اللّه تعالى ولم يَلْتَوِ، فهو حنيفٌ. أَبو زيد: الحَنيفُ الـمُسْتَقِيمُ”
فالميل للحق، والإخلاص، والاستقامة، كلها مكونات للتسليم الفعلي والجوهري لله سبحانه، إنه الإسلام الحق، وهو شرط الإيمان، تسليم وطاعة لله ولرسوله، حبا وكرامة، وعرفانا وإيمانا، وضمنه طاعة مفروضة لله ورسوله، وقبول بحكمة الله وحكمه، وبحكم النبي وحكمته الموحاة من الله، وضمنه قوله سبحانه: ” فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)”
بعد هذا، أرى أن مرتبة عليا فيها زيادة خير، وهي جوهر ما أراه ضمن المسمى العلمي المبتكر لمسمى عقائدي موجود هو علم “العلم بالله”، أي تقنين للعلم بالله وبيان معانيه وحقيقته ضمن علم مستقل وهو أمر غير مسبوق ككل ما في البرهان من نفحات واستنباطات وابتكارات.
هذه المرتبة كما أعتقد، هي بعد الإيمان والتسليم الفعلي للموجد، ولكن ليست تجاوزا بل ترقيا، فالإسلام لله، أو ما أسميته “التسليم بالوجود”، مرحلة من الإسلام عامة، من الدين وحقيقته القلبية والفعلية، ولكن هذه المرحلة وهذه المرتبة يقع تجاوزها كليا حين يصل الإنسان إلى الإيمان الحقيقي الفعلي، وما أسميته “التسليم للموجد”، وهنا يلامس المعنى الحقيقي للإسلام، ويصل الإيمان قلبه فينيره، ونفسه فيزكيها، فيسلم وجهه لله مستقيما محسنا مخلصا واثقا موقنا، وهذا التجاوز ليس تجاوزا للإسلام لله، بل تجاوز للحالة العرضية من التسليم بالوجود، إلى الحالة الجوهرية من التسليم للموجد، فيكون حينها مسلما لله ضمن إيمانه الفعلي به، لا مسلما لله ضمن كلام يقوله بلسانه وليس في قلبه منه شيء، وآية: ” قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (14)”
فيها نفي للإيمان عن من أسلموا قولا، وفيه أن الإيمان لم يدخل قلوبها بعدهم، فهم في طور الانتقال والتحول من مرحلة إلى أخرى، رغم أن قولنا عن المرحلة الأولى أنها إسلام لله بشكل عرضي فلا يعني ذلك أن الإسلام لله لا يكون تسليما حقيقيا، ولكن ذلك يأتي بعد الإيمان الحقيقي فيندمجان معا فيكون إسلاما إيمانيا، وقد يحملنا هذا إلى مفهومات تحتاج نظرا كالإسلام لله والإسلام الإيماني لله وما بينهما من فروق بين القولي العرضي الظاهري، والفعلي الجوهري الباطني ثم حقيقة الإسلام وهو اتحاد الفعل بالقول والجوهر بالعرض والظاهر بالباطن، وهذا الإتحاد لا يكون حقيقيا في نظري إلا عند الوصول للرتبة الموالية التي هي في اعتقادي قمة الإيمان، وهي “العلم بالله”، فذلك أحسن العلم، وأفضله، وأشرفه، وذلك تاج لا يناله إلا قلة، فيه الحكمة الحق، والصراط الأقوم، والخير الأفضل، والمقام الأجل…..