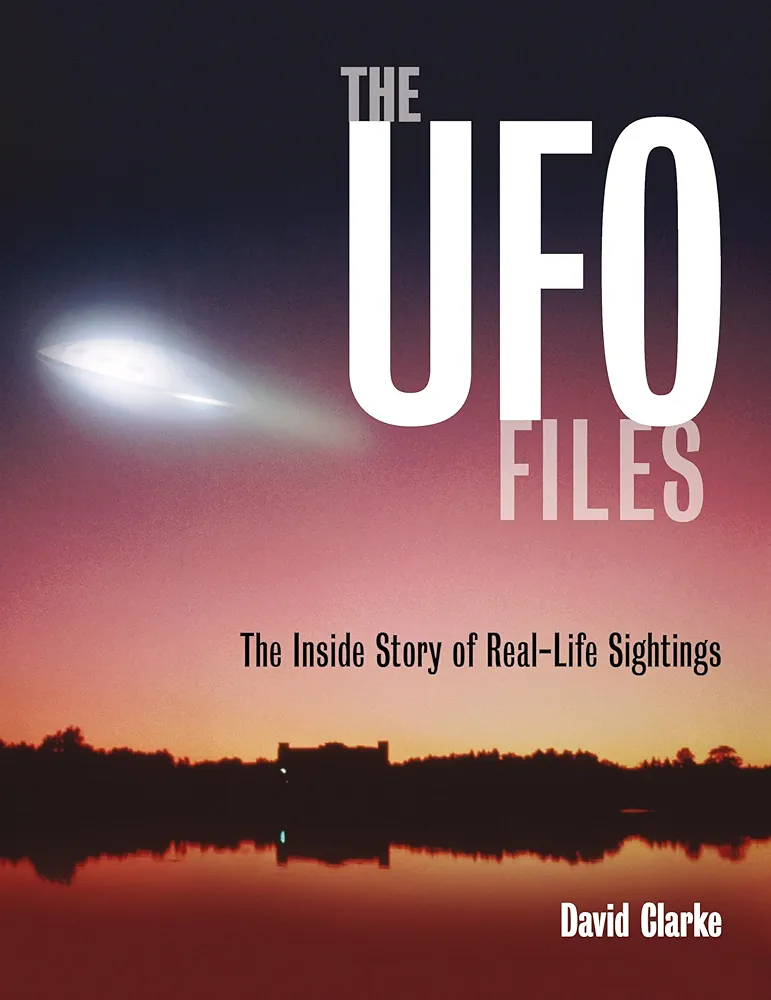نيبيرو النجم الثاقب: رصد قرآني (الجزء الأول)
10 دقائق للقراءة
نؤمن جميعا أن هذا الكون ملك لله، وأنه رب الملكوت وصاحب الجبروت.
ونعني الكون بما فيه، ما يظهره وما يخفيه، وهذا يقين لدى البشر عامة مهما اختلفت الزوايا والاعتقادات، فمن يشركون مع الله آلهة أخرى أو يعبدون الشمس والقمر والطوطم يؤمنون برب أعظم وأقدم وأشد قوة، وفق ظنهم وما كان من صراع يقينهم الفطري الذي لا يخلو منه مخلوق بوجود خالق واحد، وتلاعب أبالسة الجن والانس في التفاصيل والتحريفات.
وحتى أشد الناس إلحادا سيما علماء الكونيات والجزيئات والبيولوجيا الذي يتصدرون منابر الملاحدة اليوم، يوعلى رأسهم دوكنز وهوكينغ المتوفي منذ فترة قصيرة، يؤمنون في صميم أنفسهم بوجود الخالق، لكنهم يجحدون كما جحد الذين من قبلهم، رغم الاستيقان الكامل: “وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (14)” (النمل)
والله سبحانه يثبت أن سؤالهم عن الخالق سيفضي في الحقيقية إلى إجابة واحدة مهما تم التلاعب عبر الكذب والادعاء: “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (38) (الزمر)
كما أثبت العلم البشري المادي أن الأرض تعرضت لسلسلة من الضربات أدت إلى عدد من الانقراضات الكلية لكائنات بأكلمها مع كل ما يحيط بها من بيئة، مثل الديناصورات وما كان يعيش معها وما كانت تعيش فيه حيث تغيرت البيئة الأرضية بشكل جذري، أو ضربات أدت إلى زوال مدن وحضارات بأكملها (لغز اندثار حضارة المايا أو ما أصاب مدينة بومباي الرومانية التي بقيت آية شاهدة بما فيها من جثث متحجرة وأعين جاحظة ونظرات وملامح توحي برؤية شيء مرعب والتعرض لأمر شديد، وقد ذكر القرآن الكريم شواهد ومشاهد من ذلك.
وكذلك ما حصل في زمن الطوفان من إبادة لمعظم البشرية والمخلوقات الأرضية، وما يشاع حول أطلانتس وما وجد من كتابات عنها لدى الفراعنة والسومريين وغيرهم.
كنا عرضنا فيما سبق بعضا من ذلك، ونمضي هنا إلى السفر في مسألة الوعد الإلهي أو وعد الآخرة، من باب آية عجيبة يكتنفها الغموض، ومن خلالها ننظر إلى الماضي السحيق وإلى المستقبل القريب.
يقول الحق جل وعلا: “فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59)” (الذاريات).
جاء في تفسير الطبري حول معنى الذّنوب: “وهي الدلو العظيمة….وإنما أريد بالذنوب في هذا الموضع: الحظّ والنصيب; ومنه قول علقمة بن عبدة:
وفـي كُـلّ قَـوْمٍ قَـدْ خَـبَطْتَ بنعمَة فَحُــقَّ لِشَـأس مِـنْ نَـدَاكَ ذَنُـوبُ”.
أما تفسير البغوي فجاء فيه: “( فإن للذين ظلموا ) كفروا من أهل مكة ( ذنوبا ) نصيبا من العذاب ( مثل ذنوب أصحابهم ) مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود ، وأصل ” الذنوب ” في اللغة : الدلو العظيمة المملوءة ماء ، ثم استعمل في الحظ والنصيب ( فلا يستعجلون ) بالعذاب يعني أنهم أخروا إلى يوم القيامة “.
أما في تفسير القرطبي فقد ورد: “فإن للذين ظلموا أي كفروا من أهل مكة ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة . وقال ابن الأعرابي : يقال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضي . وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة “.
في حين جاء في تفسير السعدي: “أي: وإن للذين ظلموا وكذبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، من العذاب والنكال { ذَنُوبًا } أي: نصيبًا وقسطًا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب.
{ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ } بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب، ولو تأخر عنه مدة، ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة”.
ولقد حددت الآية الموالية من سورة الذاريات، وهي آخر السورة، تفصيلات مهمة: “فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)”. أي أنه يوم محدد متصل بالوعد.
ذهبت التفاسير التي أوردناها آنفا إلى أن الذنوب نصيب من العذاب مؤجل إلى يوم القيامة، مع أن الأصل اللغوي للكلمة هو الدلو الكبيرة الممتلئة.
وكنا بينا من قبل وجود نوعين من العذاب المؤجل في القرآن الكريم: عذاب في الدنيا، ثم عذاب الساعة وما بعدها.
الأول هو ما يتم في وعد الآخرة أو يوم الدينونة كما تم ذكره في التوراة والانجيل. فهل من دليل في القرآن الكريم.
يقول الحق جل وعلا في سورة مريم: ” “قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75)”.
وهنا يتم إمداد الضالين المضلين زمنا وقدرة، وهذا يتصل بآية بني إسرائيل في سورة الإسراء المتصلة بوعد الآخرة: ” ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6)”، وهذا ما تم فعله ونعيشه عيانا.
ثم في الآية فصل بين العذاب وبين الساعة، أي هو عذاب مرئي يأتي على أهل الأرض بعد أن يبلغوا من الطغيان مبلغا يفوق من سبقهم، ثم تأتي الساعة، فيكون ذلك العذاب أمرا من الله سابقا للساعة وأحد أشراطها، وقد تم التعبير عن ذلك أيضا ببعض آيات ربك: “هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158) “(الأنعام)
فبعض الآيات هنا يعني يوما محددا سابقا للقيامة، وإتيان الملائكة قد يكون بعده مباشرة حيث يرى البشر جنود الله عيانا، أو خلاله، أو ربما كما ورد التفسير عن ملائكة الموت، أو مشهد الملائكة صفا يوم القيامة وفي مشهد الحشر العظيم. ولكن لا يخلو من إشارة إلى نزول جنود السماء إلى الأرض في مشهد منظور ومنتظر مرتقب مرقوب. وفيه ما فيه من ظهور قوة الجيش الالهي ضمن أشراط محددة متصلة ببعضها.
بداية الآية مكررة في سورة النحل ضمن نفس التفصيل ولكن مع تغيير الأمر من بعض الآيات إلى الأمر الرباني والأمر هنا يتصل بالآية العظيمة وبالوعد مع نزول الملائكة وظهورهم عيانا: “” هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) (النحل).
وللإشارة فالآية تربط هنا بين الآتي وبين ما حدث للأمم السابقة من استعلاء ومن تكذيب ثم من ظهور العذاب منظورا مشهودا بعد انتظار حجود وعناد لأن الأنبياء يحذرون أقوامهم من العذاب قبل أن يتم عليهم وشواهد ذلك كثيرة كأقوام شعيب وصالح وهود ولوط ونوح، وكخبر فرعون.
وهنالك آيات كثيرة تفصل بين العذاب الأول والعذاب المتمثل في الساعة وأهوالها وزلزلتها والعذاب الأبدي للمخلدين في الجحيم. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه في سورة الكهف : وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55)”.
وقد تحمل “أو” هنا معنى العطف: تأتيتهم سنة الأولين أي عذابهم الشديد والعقاب المباشر للقرى الفاجرة، ويكون العذاب مباغتا كما باغت الله به الأقوام الأولى.
وإن عذاب الذين تتوفاهم الملائكة تعذيب شخصي لهم يضربون وجوههم وأدبارهم، ولكن العذاب المشار إليه هو عقاب جماعي في الدنيا بهلاك محتم، ثم عذاب جهنم أشد، وقد اجتمع المعنيان في قوله سبحانه في سورة الأنفال: “وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52).
فالعذاب عام والتعذيب فردي.
وإن تأجيلهم كما سبق التفصيل خاص بأمة معدودة تتوفر فيها شروط محددة، وهي شروط توفرت في جميع الأمم السابقة، فيكون اجتماعها في الأمة المعدودة لآخر الزمان ولوعد الآخرة اجتماعا مضاعفا: يتضاعف شذوذ قوم لوط مئات آلاف المرات: من قريتي سدوم وعمورية إلى الكوكب كله وملايين الشواذ والزواج المرخص بالقانون والنوادي والأفلام وزواج رئيس حكومة أوروبية من صديقه وغير ذلك مما يجعل قرية قوم لوط مجرد نقطة في محيط.
ظلم وشدة وبطش قوم شعيب، عناد واستكبار عاد وثمود، طغيان النمرود، تأله وبغي وفساد فرعون. ماذا يعتبر كل ذلك أمام الحرب العالمية الأولى والثانية وما يجري اليوم وما تمتلكه الدول العظمى من أسلحة نووية وترسانات عسكرية وأساطيل. وماذا كان فعل فرعون والنمرود في الناس من بطش أمام انفجار قنبلتي ناكازاكي وهيروشيما، أو ما فعله هتلر وستالين وفرانكو وتشرشل؟.
وبما أن الحرب الأولى وكذلك الثانية لم تكن المعنية بالوعد والأمة المعدود، فالأكيد أنها الثالثة، والثلاثي رمز الاكتمال، وكان رسول الله إذا كرر قولا قاله ثلاثا.
الأمة المعدودة سر عظيم في القرآن الكريم، وكما بينت فإني أرى أن قصص الأمم السابقة كانت إشارات لما سيأتي، لتلك الأمة المعدودة، لملامحها التي هي نسخ مطورة من تلك الأمم الأولى وما كان لديها من أنواع الفساد وصنوف الشر: “وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8)” (هود).
حين تخاطب جاحدا اليوم من أدعياء العلم المادي والملاحدة، أو قائد دولة عظمى، عن عذاب الله القادم، سيسخر منك، ويقول لك ما الذي يحبسه عنا، ألم نقتل وندمر ونخرب ونستعمر الأرض ونهتك العرض ونمنع الفرض، ألم نسخر من الخالق جهرة وننكر وجوده ونثبت بالعلم الذي لا يطاله شك أنه مجرد سد للثغرات ومجرد أسطورة بالية فضحها العلم، وأنه ليس سوى خلل لدى الإنسان كان يفسر به العالم لجهله وخوفه واليوم بلغ كمال العلم وظهر له أن لا خالق ولا قيامة ولا شيء.
إنه أمر حقيقي يمكن أن تجد عليه آلاف الشواهد، في حضارة البشر اليوم، فالملاحدة يصرحون ويسخرون من الخالق وينكرونه، ويسخرون من المؤمنين وينسبون إليهم الهلوسة، وزعماء العالم الكبار لا يزدادون إلا عنجهية وقوة.
لقد غر البشر ما بلغوا حتى قال حالهم قول عاد: ” فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً “.
ليكون الرد الرباني القادم طباقا للرد القديم: “أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (16) (فصلت)
وإن الآية التي افتتحنا بها تحمل مفتاحا من مفاتيح العذاب القادم والعقاب القريب، وإني على يقين معرفي وعرفاني، أن زعماء العالم ووكالة الفضاء الامريكية والكثير من كبار العلماء في الفيزياء الكونية والفلك وغيره موقنون مما ذكرت في وسأذكر في هذا الكتاب، ولئن كان على فهمهم غشاوة، وكان ربطهم بين تفاصيل المشهد الكبير ربطا ضعيفا. كما ان علماء التوراة أشد يقينا لوجود التفاصيل في النسخة الأصلية من التوارة، وفي ما صح عن السيد المسيح.
إن الذَّنوب هي الدلو الكبيرة، وتم حمل المعنى إلى النصيب، وهذا لا اختلاف فيه، لكن القرآن بحر من المعاني، تتناسب معانيه مع مباني الوقت والفهم الخاص بكل عصر، ولهذا العصر خاصيات غير مسبوقة، هي في الحقيقة مما أظهر الله وما قدر وسطر، وليست مما فعل البشر خارج سياق التقدير والعلم الالهي، فكل شيء له حسبان دقيق وقدر مضبوط لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا بداء بل إبداء.
فماذا لو كان الذَّنوب رمزا للعذاب، شبيها بعذاب أصحاب الذين ظلموا، أي من كانوا ظلمة قبلهم، ويكون هذا الذّنوب كبيرا متدليا (في صلة بالدلو الكبير) ولكنه ليس دلوا بل مذنّب، كوكب له ذنب كبير، سبق وأن زار الأرض وسبب هلاك أمم من قبل، وسيرجع.
وأن هذا الذَّنوب هو عقاب على الذُّنوب، وللظالمين في يوم محدد نصيب منه كما كان لأصحابهم من قبلهم نصيب.
وماذا لو تم رصده من قبل والكتابة عنه والتحذير منه رجوعه، وأن البشر اليوم تمكنوا من رصده أيضا، بعد غيابه في مساره البعيد في أطراف المجرة أو المجموعة الشمسية.
ماذا لو تعلق الأمر بشيء قادم من فوق يتدلى من السماء إلى الأرض، يحمل العذاب الذي تراه العين.
لابد لمصداقية هذا الكلام من شواهد ثلاثة: شاهد من القرآن الكريم. شاهد من التاريخ. وشاهد من الواقع اليوم. والجمع بين الشواهد يفيد في الفهم والتحقق.
في القرآن الكريم سنعتمد على عينة من الآيات فقط، أولها قوله سبحانه وتعالى:
أي أن الرزق في السماء تقدير، وكذلك الوعد (وما توعدون).
قلنا أن المعني الأساسي من كلمة الوعد هم الذين تحدوا الله ورسوله، بسابقة تمتد إلى سيدنا موسى وتنتهي بانتهاء المهلة وتحقق وعد الآخرة ونفاذه. ووعد الآخرة تم تكراره كثيرا في القرآن الكريم كمسألة مفصلية وتحد إلهي تم ذكره في التوراة وتكراره في الانجيل وظهر اوله مع نبوخذ نصر حين دمّر دولة بني إسرائيل الأولى. ثم تم تجديده بفترة تمتد من بعثة سيدنا رسول الله إلى ظهور الأمر بتفاصيله في الوقت المحدد في صلة ببني إسرائيل وهم الأكثر ذكرا في القرآن الكريم والمعنيين مباشرة بالوعدين السابقين في الكتاب أحدهما تم والثاني سيتم.
في السماء ما توعدون: ألا يحمل ذلك ضمن ما يحمله وجود سلاح خاص سيأتي من السماء وينزل على الأرض ضمن “بعض آيات ربك” أي ضمن آية عظيمة قوية فيها عذاب شديد أليم.
ألا يشير ربما إلى كوكب يختفي في السماء، بعيدا، وينتظر موعده المتجدد ووعده الأكيد.
ألا يكون بعضا من قوله جل في علاه: ” إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4)(الشعراء).
إنها آية من السماء ستأتي فيها الوعد. وإن السماء تحتوي تلك الآية لحظة نزول آية القرآن على الحبيب الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي آية ستخضع لها الأعناق ويراها أهل الآفاق. فهل من دليل قرآني آخر أكثر تفصيلا؟
يقول الحق سبحانه في سورة الأسرار والوعد والإشارات سورة الاسراء: ” أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا (92)”. ومفتاح الآية (زعمت) أي أن رسول الله أخبرهم أن الله سيسقط عليهم في أمة ما أو فترة ما كسفا من السماء، قطعا من السماء. فهل من إشارة قرآنية لذلك إن لم نظفر بحديث فيه ذلك الكلام المحمدي الذي هو في نظر الكفار والمكذبين مجرد زعم رغم يقينهم من صدقه. وهو بذلك وعد رباني بلسان محمدي مؤجل إلى فترة وأمة بعينها.
بلى في القرآن إشارة إلى ذلك أكثر وضوحا:” أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (9).
وهي بحر من المعنى: نظر البشر إلى الأرض والسماء الذي تطور حتى بلغ مبلغه اليوم من تفاصيل علوم الأرض والكونيات. ثم إشارة إلى خسف قادم، وإلى سقوط كسف من السماء بشكل يقيني يتصل بعمق المعرفة بأسرار الأرض والكون حتى تظهر الآية وتتضح ويكون البرهان قاطعا والعقاب لازما.
” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)” (فصلت). وتبيان الحق فيه تبيان أن الوعد حق، ولقد تمكن البشر اليوم عبر المجهر الالكتروني وعلوم الجينوم البشري وعبر مرصد هابل وعلوم الكونيات من التحقق من آيات النفس والآفاق بشكل لم يصل إليه الناس زمن رسول الله ولا في معظم التاريخ البشري، لقناعتي بوجود طفرات حضارية وعلمية أعظم أو مثل هذه خاصة أطلنتس.
وحين تجد قوله سبحانه إن نشأ فاعلم أنه يعني قد شئنا ولكن في موعده ووقته. وكل الآيات التي تحمل هذه الكلمات أو ما يشبهها (كقوله ولو نشاء) تعني نفس المعنى، كقوله سبحانه في سورة يس: ” وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ (43) أو كآية “إن نشأ” السابقة وفيها ما تظل له أعناقهم خاضعين. فالاحتمالية في القرآن لا تعنيها بالضرورة، كقوله سبحانه: ” قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (144) (البقرة). أي إننا نرى. أو قوله” وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97)” (الحجر) أي إنّا نعلم أنه.
إذا سقوط الكسف من السماء وعد إلهي ضمن شروط وتفاصيل، وليس هنالك من معنى أقرب ولا أوضح من النيازك. إنها قطع في السماء، بقايا كثيرة وأحزمة عديدة.
يتصل هذا بآيتين من القرآن الكريم فيهما مزيد من الفهم والوضوح، الأولى قوله سبحانه:
” فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10)” (الدخان).
والثانية قوله: “وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3)” (الطارق).
فالدخان المبين القادم من السماء قد يحمل إشارة إلى كوكب او نيزك، كما سيأتي تفصيله.
أما الطارق فهو نجم ثاقب له مواصفات محددة مميزة، ولم يقسم الله به عبثا. فهو سيطرق أبواب الأرض يوما ما كما طرقها من قبل. أو يتخذ إلى الأرض طريقا.
وتجد في جميع الآيات السابقة ذكرا للسماء، فالمعني سماوي أي قادم من الفضاء الخارجي للأرض، فيه كسف أو قطع، وفيه دخان، وفيه طارق، وفيه آية عظيمة تخضع لها أعناق البشر. كل هذا في إشارة للوعد وفي إشارة للذّنوب. وحين نعمق الغوص سنفهم الكثير. لكن قبل ذلك لننظر في البرهان التاريخي والبرهان العلمي.
21/06/2019
# الدكتور مازن الشريف، فكر، قرآن، نيبيرو